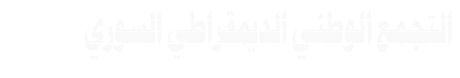بدأ مالك بن نبي حديثه عن السياسة والفكرة في كتابه شروط النهضة بعبارة جميلة فقال: “إن الكلمة لمن روح القدس، إنها تُسهم إلى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعيّة، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شديد، إذ تدخل إلى سويداء قلبه فتستقرّ معانيها فيه لتحوّله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة، فالكلمة ـ يطلقها إنسان ـ تستطيع أن تكون عاملًا من العوامل الاجتماعية حين تثير عواصف تغيّر الأوضاع العالمية”.
أوهام السياسة
وقد ضرب مالك بن نبي المثل في أثر الفكرة في بلده بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقال: “لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات بن باديس، فكانت تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدَّر يتحرك، ويا لها من يقظة جميلة مباركة، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتين بالنوم، حتى أُشرِب الشعب في قلبه نزعة التغيير، وأصبحت أحاديثه تتخذها شرعة ومنهاجًا، وهكذا استيقظ المعْنَى الجماعي، وتحولت مناجاة الفرد إلى حديث الشعب”.
ثم تجاوزت اليقظةُ الجمعيةَ ذاتَها، وكانت ثورةُ نوفمبر/تشرين الثاني من ثمارها الزكيّة. وكان نوفمبرُ قبل الثورة كلمةً في البيان الأول من هذا الشهر من عام 1954. بيانٌ دعت أهدافه إلى الاستقلال ضمن الحرية والتضامن الاجتماعي والمبادئ الإسلامية، وإلى تحقيق وحدة الأمة من الشمال الأفريقي، إلى إطاره الطبيعي العربي الإسلامي، ولا تزال المسيرةُ لم تكتمل، فهي مستمرة تتطاول على مكائد الاستعمار وأذنابه.
إن كل تلك الحركات الإحيائية عملت على أساس أن تكوينَ الحضارة بوصفها ظاهرة اجتماعية، إنما يكون في الظروف والشروط نفسِها التي وُلدت فيها الحضارة الأولى، في بيئة المدينة المنورة، على حد قول بن نبي. فإن بقيت الفكرة تصنع تلك الظروف فلا بدّ للحضارة أن تبزغ من جديد، فإن تبعت الفكرةَ السياساتُ والمؤسسات والأطرُ والهياكلُ والمناهجُ، ولم تغادرها أبدًا مهما كانت الصعوبات والتحديات، بلغت – بإذن الله – مبلغها نحو بزوغ فجر جديد.
غير أن بن نبي عاب على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين – التي رأى أنها نهضت بالمجتمع الجزائري في عقد واحد من الزمن فقط بين 1925 إلى 1936 وهيأته فرديًا واجتماعيًا لينعتق من الاستعمار – أنها قد نزلت إلى أوهام السياسة على غير فكرتها، حينما انخرطت في مطالب الاستعمار بالإصلاحات والحقوق في المؤتمر الإسلامي عام 1936، مع نخب سياسية ليست لها فكرة حضارية ولا وجهة ثقافية، ولا تريد من الاستعمار إلا أن يحسّن ظروفها.
اغتيال الإصلاح
لم يتّهم بن نبي جمعية العلماء في مقاصد قادتها، مُبدِيًا أسفَه على زلة العلماء التي كانت زلة نزيهة، لما توافر فيها من النية الطاهرة والقصد البريء، كما قال، وذلك حين سمحوا عام 1936 بسقوط الفكرة الإصلاحية في حبائل الوعود التي بذلتها الحكومة الفرنسية اليسارية بغير حساب، وهي تعمل في الحقيقة على اغتيال الإصلاح.
ويمكننا أن نأخذ في الوقت الحالي على الحركات الإحيائيّة في التيار الإسلامي، التي أحيت الأمة وصنعت صحوة شعوبها في آخر القرن الماضي نفس المآخذ التي أسف لها بن نبي عن جمعيّة العلماء المسلمين في أواخر الثلاثينيات، إذ بدل أن تنتقل تلك الحركات إلى معامع السياسة بفكرتها، صار الكثير منها ينافس على الانتقال من مساحات الدعوة في المُجتمع إلى مؤسَّسات الدولة الحديثة بدون الفكرة التي تميزها، وصار مبلغ علم قادتها أن يُسمح لهم بهوامشَ في الوجود السياسي ضمن عملية ديمقراطية مغشوشة لا يوصل سقفُها المتدني إلى التغيير، ولو بقوا في العمل على ذات المنوال مائة سنة مقبلة.
وضمن هذا المنظور السياسي البراغماتي الجديد صار الوجه البارز ـ وربما الوحيد ـ لتلك الحركات هو الوجه الحزبي المندمج في المنظومة الفكرية الحضارية الغربية المهيمنة في بلداننا وفي العالم بأسره، وفي أحسن الأحوال وجه أحزابٍ مُحَافظةٍ تهتم بمظاهر الهوية وقوانين الأحوال الشخصية دون مشاريع جادة لعبور الفكرة إلى مستوى العودة الحضارية للأمة الإسلامية.
“علم الأفكار”
لقد برزت أصواتٌ خدّاعة بعد هيمنة الرأسمالية العالمية تدعو القوى الإسلامية إلى ترك “الأيديولوجية” والاهتمام بمصالح الناس فحسب في الممارسة السياسية، وما تلك الدعوة إلا لإزاحة كلّ الأيديولوجيات لتبقى أيديولوجيةٌ واحدةٌ مهيمنةٌ هي أيديولوجية الرأسمالية التي ضيعت مصالح غالبية سكان المعمورة لصالح فئات قليلة سيطرت على أغلب خيرات الأرض.
وإذا كان معنى كلمة “الأيديولوجية” هو “علم الأفكار”، كيف يُتصور ألا تكون الفكرة قبل السياسة؟. لقد أدى تجريم علم الأفكار إلى أن صارت الأحزابُ في العالم كلُّها متقاربةً في مساحة سُميت ظلمًا الوسط أو “الوسطية”، ببرامج متشابهة، يختارها الناخبون في الظاهر، ولكن تتحكم فيها قوى غير معلنة ولا مسؤولة هي القوى المالية والعسكرية والشركات الكبرى ولوبيات الأقليات الممكّنة.
تأخذ القوى الخفيةُ السلطةَ الحقيقية وتتهالك القوى الحزبيةُ البارزةُ على فتات المقاعد البرلمانية والوزارات والمصالح، فلا تسمع في النقاش السياسي شيئًا عن الأفكار والتوجهات الحضارية، وكيف تصان الكرامةُ الإنسانية، ولا تسمع شئيًا عن طبيعة الدولة المنشودة، ولا عن الرؤى الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية المناقضة لأيديولوجية السوق، وبرامج إطلاقِ الغريزة المحبطة للفضيلة، وأما أزمات الشعوب فعلاجها الوعود الانتخابية، أو تعميق الأزمات لوضع طموحات الناس في مستوياتها المتدنية.
إن ابتعاد المصلحين عن فكرتهم، بعد أن تطول بهم الطريق، يُضيِّع منهم المبادرة فيأخذها الأكثر جسارة منهم، ولو بدون أفكار حضارية فيطول شقاء الأمة، في إطار الدولة الحديثة التي صارت تشقى تحت سلطتِها الدُّغماتيةِ كلّ البشرية.
لا شيء يجب أن يحافظ عليه قادة حركات الإحياء الإسلامي أكثر من الفكرة التي أسستهم، والتي وحدها تتناسب مع قواعد المجتمع الذي نَبتُوا فيه وإلا صارت أحاديثُهم جوفاء بلا مضمون مهما تنمّقت، وصدق بن نبي إذ يقول: ” ومن الواضح أن السياسة التي تجهل قواعد الاجتماع وأسسه، لا تستطيع إلا أن تكوّن دولة تقوم على العاطفة في تدبير شؤونها، وتستعين بالكلمات الجوفاء في تأسيس سلطانها”. ولعل صدمة “الطوفان” تصلح الأوضاع.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لتجمع الوطني الديمقراطي السوري
د. عبد الرزاق مقري
مفكر وكاتب سياسي، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة ونائب رئيس البرلمان الجزائري سابقًا
المصدر الجزيرة.