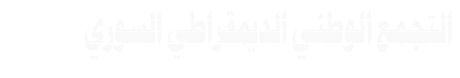بيني وبين خالتي عشر سنوات من العمر، في البداية كان الفرق كبيراً لا يعد بالسنوات، بل يحسب بالحجم وبسنين الدراسة أو العمل، كنا خالة وابنة أختها، بدا حينها الفارق كبيراً جداً وجرت العلاقة كعلاقة احترام وشعور يفرض فرقاً عمرياً كبيراً بيننا.
عندما كنت طفلة غير مكتملة الملامح ولا الحجم في الثامنة من عمرها تتلهى بألعابها وتبكي من تعب الكتابة والتعلم المبتدئ، كانت خالتي شابة يافعة وأقرب لفئة الكبار، أنهت دراستها الثانوية وصارت معلمة بدوام جزئي مع متابعة دراستها الجامعية، كان الفارق كبيراً حينها عمراً وتوصيفاً وأداءً.
اليوم وبعد خمس وخمسين سنة، تقلص الفارق بيننا، بتنا أقرب إلى بعض في الشكل وفي الاهتمامات، تقاعدنا من العمل، نمتلك وقت فراغ طويلاً ونتوافق على الكثير من القضايا والتفاصيل، وكأن ما يجمعنا بشكل رئيسي هو الخبرة الحياتية والاهتمامات المشتركة وليس القرابة، وكأن السنين العشر الفارقة بين عمرينا قد تبخرت فجأة.
لكن للغياب والوحدة قول آخر، تصرّ خالتي على أنني ما زلت تلك الطفلة الصغيرة التي يتوجب عليها الآن رد ديون خالتها كلها، طابات البوظة الملونة والابتهاج العارم بها، النزهات الصغيرة إلى حديقة الحي، دفع الأرجوحة الحديدية إلى أقصى مسافة ممكنة، قوالب الكاتو في أعياد الميلاد، لهفة الاستقبالات والضمات الواسعة عند اللقاء في بيتنا وعند زيارتها في بيتها بعد زواجها.
تكاد أحوال المتقاعدين تتطابق، ولو بفارق في العمر، قد يصل إلى عشر سنين، لكن خالتي اليوم امرأة وحيدة، أرملة لم تنجب أطفالاً، صرت فجأة ابنتها الوحيدة مع أن فارق السن بيننا لا يسمح لها أبداً بأن تكون أمي، فرضت حاجتها الماسة لوجود شريك حقيقي لها وقربي منها في العواطف والسكن أن نكون أماً وابنتها، مع أننا أقرب إلى أن نكون أختين أو صديقتين.
بعد التقاعد، تنهدم الأحلام وتتبخر المشاريع التي تعيد للنساء جزءاً من خصوصيتهن المفقودة، أحلامهن بالنوم حتى ساعة يرغبن فيها
يبدو أن خالتي أقنعت نفسها بأنها أمي فعلياً، وكادت تقنعني بأنني ابنتها كي تطلب مني كل شيء دون أي تردد. وجدت نفسي فجأة متورطة في بنوة طارئة، عليَ الإذعان لها والقيام بمسؤولياتها بكامل الرضا والسعادة باكتساب أم جديدة.
أنا المرأة الستينية التي أعدت الكثير من الخطط ما بعد التقاعد، جداول من زيارات لأماكن لم أزرها من قبل، التعامل مع الوقت حسب مزاجي وملؤه حسب أولويات رغباتي وليس بصورة مرتبة وصارمة كالسابق. في جعبتي أيضاً عناوين لا تحصى لكتب وخاصة من الروايات جمعت عناوينها واشتريت بعضها وجدولت مواعيد قراءتها، لكن دون أي بارقة أمل أو فرصة تسمح لي بتحقيق ذلك.
بعد الستين، وهو سن التقاعد يطلب من المتقاعدات رعاية الأهل، وكأننا بلا أي انشغال، وكأننا بدأنا حيواتنا العملية للتو، نصبح مرغمات على الالتزام بعمل يومي وساعيّ جديد. قد يطلب الزوج منا التوجه نحو القرى البعيدة لاستثمار أرض زراعية صغيرة رغم أنها مهملة لزمن طويل، لا تتجاوز مساحة حديقة المنزل.
تصحو فجأة المشاريع العائلية وتُعلن الرغبة في الاستثمار والتوفير فقط بعد تقاعد النساء، والأهم والأكثر مدعاة للتعب أنّ المتقاعدات يصبحن فجأة جدات مرغوبات ومحبوبات، عليهن رعاية الأحفاد حتى خارج أوقات عمل أمهاتهن، تبالغ البنات أو زوجات الأبناء وحتى الأبناء في عجزهم عن دفع رسوم الحضانات، ويتباكى الجميع أمام الأمهات المتقاعدات من قسوة مشرفات الحضانة والمعلمات في رياض الأطفال. يكتشفون أماتهم فجأة، وكأنهن قادرات ومرتاحات، وكأنهن اكتفين من سرور الدنيا ومن القراءة التي يعشقنها أو تبادل الزيارات مع الصديقات لشغل الوقت بالضحكات والمناقشات المهمة والمتكافئة مع صديقات لهن ذات العمر وذات الاهتمامات.
بعد التقاعد، تنهدم الأحلام وتتبخر المشاريع التي تعيد للنساء جزءاً من خصوصيتهن المفقودة، أحلامهن بالنوم حتى ساعة يرغبن فيها، إنها السن المظلومة، إنها بوابة جديدة من التعب والالتزام وتغييب الخيارات أمام النساء.