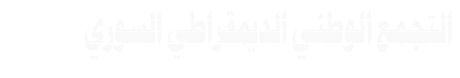أردّد منذ فترة عبارات تتقافز إلى ذهني من دون أيّ حولٍ مني ولا قوة، فتارة أردّد مقولة الشاعر محمود درويش “ظلّ الغريب على الغريب عباءة”، وطورًا أترنم شطرًا للشاعر حذيفة العرجي “هذي البلاد لنا لكننا غُربا”، وأحيانًا أستمع مرارًا لقصيدة محمد عبد الباري النسخة الثانية من الغريب، وأقف مليًا عند قوله: “ودُفِنْتَ في الغيبِ، الذي لا لنْ يُرى أبدًا.. وفي السرِّ الذي لَنْ يُسمعَا”، ولكنها جميعًا عادت تحضر بقوة صارخة في هذه الأيام، كأنها وجوهٌ تستصرخ كلّ حرفٍ فيها بعد الفجيعة الجديدة، وتطالب برثاء الغريب للغريب.
ربما لا نُحسن كتابة المراثي، فنحن من جيلٍ ما عاش رفاهية الوقت لها، تدبيج العبارات الرنانة، والبحث عما يناسب لمن يناسب، ذرفنا الدمع شهداء في محارق الأرض، وأنبتنا الصبر من ثنايا الآمال التي لا تتكرّر، لقد عاش جيلنا عددًا لا يُحصى من المحن، لن يكون هذا الزلزال آخرها، بكلّ تأكيد، فنحن من الجيل الذي شبّ في لبنان، وكذا بلاد الشام، على أخبار الحرب الأهلية، وذلك الإرث الثقيل الذي حملناه منها، وتقسيماتٍ بدت أطياف ماضٍ موغل في القدم، إلا أنها حقائق تعاود كل حين، وفُتحت عيوننا على احتلال متوحش في جنوب لبنان وفي فلسطين، وكانت مجازره صورة الدم الأولى المراقة في هذا الأتون المستمر.
ولم تكن تلك هي ذكرياتنا الوحيدة، فقافلة الهزائم أناخت ركائبها في بلادنا، فكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول شرارة لكي يشتعل شرقنا المكلوم مجددًا، فكانت حملات لغزو أفغانستان ومن ثم العراق، وما جرى بعدها من اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وبعد ذلك بسنوات اغتيال رفيق الحريري، وحرب تموز وحرب مخيم البارد، والحروب على غزة.. وصولًا إلى الربيع العربي ومن ثم انتكاساته التي أحالت الربيع همومًا جديدة، مُلئت بروائح البارود والتشتّت في كلّ أرض، وثبّتت صورة جديدة للوحش البشري، يبتسم أمام الشاشات ويتحدث عن المؤامرة العالمية، وهو يرتدي ربطة العنق المزركشة بنقاط بلون الكدمات على وجه أطفال درعا، في ذلك الزمن البعيد.. ولا تتوقف تلك السلسلة من المآسي التي حمّلتنا ما لا نطيق، فأصبحنا في عمر التجارب والمِحن عجائز آيسوا من الحياة وتكاليفها.
كلّ طفل يُنتشل من بين أنقاض المباني المهدّمة، كان يُحيي ألف صورة لأطفالٍ في رابعة وبانياس، وكأن ذاكرة جيلنا حُكم عليها بالموت
لقد مرت كلّ تلك المحطات سريعةً هادرة، لا تترك للنفس فرصةً لتنفض عن كاهلها بعض حمولتها المرهقة، إلا وتكون النازلة التالية قد استتبعتها ألمًا وحسرة متجدّدين، وتترك وقعها في روحك مرة أخرى، وما أنت إلا ذلك الغريب الذي يحاول أن يمر من بين حقول الدم والموت، وتتلمس طريقك فيما بينها بأقل الخسائر الممكنة، ولكن نفوسنا قد أثقلت بالجراح الغائرة، وتترصدنا المخاوف في كلّ خطوة وزاوية وموقف.
أعود إلى الواقع بعد هذا البوح الضروري، لقد مرّ نحو 10 أيام كانت مثقلة بالهموم والحزن، لقد أعاد الزلزال المدمّر كلّ الذكريات الماضية، وأحياها من جديد، كأنها كانت البارحة، كلما رأيت منزلًا مدمّرًا لاح في مخيلتي كلّ مآسي الحروب التي تابعنا مجرياتها وعشنا بعضها، حتى حضرت كابول وبغداد، وطرابلس وبيروت وحلب والغوطة، إنها الذاكرة المترعة بالحزن، بالفزع والهزائم.. كلّ طفل يُنتشل من بين أنقاض المباني المهدّمة، كان يُحيي ألف صورة لأطفالٍ في رابعة وبانياس، وكأن ذاكرة جيلنا حُكم عليها بالموت، موت ينازع الحياة ويبحث عن فريسة أخرى، وحياة تبحث عن ظل ترتاح فيه، فقد أعيتها كثرة الموت وتغوله.
لن أكتب عن الجهلة الذين حمّلوا الناس جريرة الزلزال، فها هي الكوارث تحدث في كلّ صوبٍ وبلد، والابتلاءات جزءٌ ركيزٌ من حياتنا، وهي اختبار من جهة ومنحة من جهة، والكلمة كما تكون بلسمًا، فهي تُخرج صديدًا وعلقمًا… ولن أكتب عنه، فإنني أكتب عن الغرباء، الذين قضوا، وعن الغرباء الذين نزحوا، وعن الغرباء الجوعى، الذين يستشعرون البرد والهم، الذين يحبسون دمعهم ليظلّ طفل صغير يقف قربهم متماسكًا مبتسمًا، الذين افترشوا الأرض، وكانت السماء لهم خيمة، عن ألف ألف غريبٍ، كانوا لبعضهم رجاءً وأُنسًا، لعمري لو أنهم ولدوا من رحم المعاناة، لن يكونوا بأتعس منهم حالًا..
تمرّ علينا هذه الأيام وكأنه ما مرّ على قلوبنا أسى قط، إذ تعود إلى ذواتنا تلك المشاعر ذاتها، نحزن ونلتاع، تذوب قلوبنا من مشاهد المكلومين، ونظل في استنزافٍ لا نهاية له، ففي مثل هذه المصائب، عين تبكي على من ارتقى من شهداء الهدم، عرفناه أم لم نعرفه، وعينٌ تبكي على المشردين في كلّ صوب ومكان. تقول لي زوجتي “توقف عن مشاهدة هذه المقاطع”. لا أدري، لم لا أستطيع، وأذرف في كلّ منها دمعًا سحساحًا نديًا، كأنني ما رأيت ما يشاكلها منذ فتحت عيناي على الدنيا، أشاهدها إذ أجد أن جزءًا من آدميتي يقف في وجهي، يستصرخني لكي تظلّ ذاكرة هؤلاء حاضرة في نفسي، لكي يكونوا أمثولة ليس للعبرة معاذ الله، بل للتحرّك والعمل، وكأن تلك العبارة التي سمعتها منذ قليل قد قيلت من أجلي فقط “التفكير في المفقود، ينسيك الموجود”.
عين تبكي على من ارتقى من شهداء الهدم، عرفناه أم لم نعرفه، وعينٌ تبكي على المشردين في كلّ صوب ومكان
أرثي في كلماتي من ارتقى في هذا المصاب الجلل، والفؤاد يصطخب بصورهم وأنّاتهم، كأنها غُصص تُصارع القريحة لكي تتحوّل إلى كلماتٍ، أبثها ها هنا، لن تصل إلى المكلومين، ولن تكون لهم لحافًا يقيهم برد الشتاء، ولا ظلًا يمنع عنهم الشمس اللاذعة، إلا أنها حيلة الذي استهلك مآخذه، وعاد لما يعرف، ينسج أحرفه على منوالٍ عاجز، ونفسٍ رقيقة، وقلبٍ صدعته المحن، ولو كتبنا رثاء في كلّ من قضى في المصاب، ودبجنا فيهم الشعر والنثر، واستخدمنا ذخائر العرب الأوائل، ستظلّ تلك الاختلاجات في الصدر أكثرَ تعبيرًا مما نكتب أو نقول.
لم أفقد من أعرفه شخصيًا، ولكنني ذُهلت من حجم المراثي التي تابعتها في وسائل التواصل، حتى أصبح الفقد سمة عامةً في هذه الأيام للشعبين السوري والتركي، فلهما، للغرباء الذين ارتقوا وما تحدث عنهم أحد، هذه كلماتي لكم، لا أعرف حكاياكم، ولن أقصّ للناس بعضًا من سيركم، إلا أنها خلجات وتحايا، وحداء في هجير اللوعة، لا تغيبوا في الفناء من جديد، وتكونوا أغرابًا مرتين، وكم أتعبنا الغياب، وكم سيتعبنا..
خسارات المرء أشباحٌ تطارده من دون توقف.. لكل منا خسارة لا يتجاوزها، ربما يتعايش معها… فالحياة قافلة ستمضي بلا توقف، تمضي بنا ونمضي معها، نغالب حزنين في هذه الدنيا.. حزن فراق بإرادة وخلاف.. وحزن فقدٍ بلا عودة، وفوق كل ذلك أتراح تشرع أبوابها لنا، لا تشبع منا ولا من دموعنا. وكما بدأت مرثاتي في تلك العبارات التي ردّدتها زمنًا، أردّد في لوعةٍ أبيات الشاعر السوري ياسر الأطرش، التي تلخص ما حاق بنا، وقد كُتبت في لحظةٍ تتشابه مع اليوم، وأخشى أن تتشابه مع لحظاتٍ قادمة، فإننا شعوب لا أهل لها ولا سند:
يا حزن يعقوب يا حزناً على ولدٍ…. ماذا تقول لمن يبكي على بلدِ؟
أشلاؤنا بعضها في الأرض مندثرٌ…. وبعض أشلائنا يصبو لملتحدِ
نَمضي قوافل موتى كلّ مرحلة…. لها نصيب من الأموال والولدِ
يا حزن يعقوب قف بالرسم وابكِ به…. شعباً وحيداً بلا أهل ولا سندِ