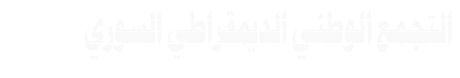بعد إصدار مجموعتها القصصية الأولى، وجهت لها شقيقتها الكبرى الطبيبة النسائية لوماً جارحاً يوازي تهديدا بقطع الدعم المادي عنها: “في قصصك إشارات جنسية وكلمات تتجاوز حدود الأدب”.
جارهم الصحافي قال لها: “كتابتك جريئة وجميلة مثلك، وأرفق شهادته بغمزة واضحة”. أما ابن عم والدها المدقق الأدبي لدى إحدى دور النشر فقد عاتبها لأنها لم تعرض عليه مخطوط المجموعة لينقيها لغوياً كما ادّعى ملمحاً إلى استعداده الدائم لتقديم خدماته الأدبية وغير الأدبية.
فجأة، صار في بيت العائلة كاتبة، وحدها الأم من أعلنت سعادتها الغامرة بنجاح ابنتها وتحقيقها حلمها القديم، مع أنها سابقاً رفضت مرات عديدة قراءة مقطع واحد من نص لابنتها، بل وسمحت لنفسها يوما بالقول لابنتها عبر رد جارح: “كله حكي بنات”.
أما أخوها، فكان يتعامل معها كطفلة عاشقة، مراهقة هائمة في التخيلات، تقع فوراً في هوى الأشياء الجميلة والكلمات العاطفية الرنانة. بينما لم يسمع الأب يوما أن لابنته محاولات في الكتابة، وهذا ما دفعه حينما أهدته ابنته مجموعتها القصصية بالقول: “الحمد لله الآن صار متأكدا أن أحدا ما سيبكي على نعشي، إذ إنه اكتفى بالتعامل مع الحدث العظيم من زاوية عاطفية أبوية بحتة”.
تحلم النساء بالكتابة، لكنهن لا يفصحن عن ذلك، يتبادلن مخطوطاتهن ولو كانت سطوراً صغيرة على دفاتر المذكرات أو مفكرة الجوالات وكأنها منشورات سرية
تحلم النساء بالكتابة، لكنهن لا يفصحن عن ذلك، يتبادلن مخطوطاتهن ولو كانت سطوراً صغيرة على دفاتر المذكرات أو مفكرة الجوالات وكأنها منشورات سرية، تغير بعضهن أسماءهن على صفحات الشاشة الزرقاء ليكتبن ما يرغبن بكتابته، متأخرات جداً، وربما بعد الستين من العمر يعلنّ أنهن لم يمتلكن يوماً الإرادة ولا قوة القرار ليصبحن كاتبات أو على الأقل ليذيلن أسطرهن المذعورة بأسمائهن الحقيقية.
في الخامسة والأربعين، قررت إيزابيل الليندي خوض تجربة الكتابة وعلى الرغم من أنها دخلتها من بابها الأوسع باب الرواية لكنها قالت: “صحيح أني كبرت في السن، لكني لن أمضي عمري في رتي جوارب زوجي وأحفادي، لذلك قررت الكتابة”.
أتذكر دوما وبطريقة حادة تعليقات زملاء الجامعة وبعض الفنانين وحتى الفنانات واعتراضهن على عنونة الكاتبة أحلام مستغانمي روايتها الثانية بـ”عابر سرير”، تحول العنوان لشتيمة للمحبين الذين ترفضهم حبيباتهم أو الذين يضنيهم الشوق ولوعة الهجر أو الغياب.
شكك غالبية النقاد والقراء المدمنون على القراءة حينها بقدرة أحلام مستغانمي على كتابة مثل هذه الروايات، وزعموا بل إن بعضهم جزم فعلا بأن رجلا هو من كتب تلك الرواية وربما روايات أحلام مستغانمي كلها، لقد عزوا تشكيكهم إلى مقولة جامدة ومباشرة وقطعية تقول: إن النساء عاجزات عن إدراك مشاعر الرجال العميقة وخاصة الجسدية، وعاجزات عن الإمساك بتفاصيل البنية العاطفية للرجال.
تكتب النساء ليحفظن الحكاية، ليعلن أنهن هنا، وأن الزمن أوسع من مهام هزيلة ومكررة كرتي الجوارب وردم حفر التغييب المزمن.
هي الحكاية ذاتها إذن، مغرقة في القدم ومغرقة في الإنكار في الوقت نفسه، تغيرت الصورة قليلاً، اهتز هيكل الاتهامات وتحولت مقولة دارجة جديدة إلى شبه حكم قطعي مستجد، بطلة أي رواية أو قصة أو حتى نص فيسبوكي دوما هي الكاتبة ذاتها، وتقوم بذلك كي تمرر كل أزماتها العاطفية وتهرب من رقابة العائلة والمجتمع عبر الكتابة.
إنه شكل جديد من أشكال التنمر المجتمعي وربما العائلي، رجال كثيرون يمنعون زوجاتهم من إنشاء صفحات على الشاشة الزرقاء، لكن المصيبة تكون أشد فظاعة عندما تتباهى إحداهن بأن منع زوجها لها هو من باب غيرة الزوج المحب.
عندما تكتب النساء تتغير الموازين وتنقلب المقاييس وتتشدد الأحكام، تصبح الأضواء فجأة أكثر سطوعا، والعين الكاشفة تكبّر علامات الاستفهام والجمل التي تهجر نقاط النهاية عمدا وكأنه تهمة مضبوطة وفاضحة، تكتب النساء ليحفظن الحكاية، ليعلن أنهن هنا، وأن الزمن أوسع من مهام هزيلة ومكررة كرتي الجوارب وردم حفر التغييب المزمن.