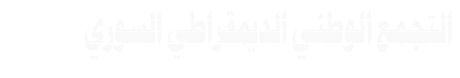شكل الاهتمام بالقدس وما تعانيه عن طريق المعرفة سمة جليلة من سمات الاهتمام بالمدينة في السنوات الماضية، وهو اهتمام أصيل ينطلق من أهمية نشر ما يتصل بالقدس والأقصى من معارف وعلوم، لتكون هذه الجرعات المعرفية لبنة في بناء ثلة من العاملين للقدس على بصيرة ووعي، وقد أتت هذه الدورات بعض أكلها في عدد من البلدان.
وعلى الرغم من هذا الدور المحوري للمعرفة، إلا أنني أستغرب من ذلك الجنوح المتزايد نحو “تعقيد” هذه الدورات، واسمح لي عزيزي القارئ “فلسفة” علوم بيت المقدس بما تحمل الكلمة من معنى سلبي، ولا أقصد ها هنا ما يتصل بالمتخصصين المبدعين ممن يعيد إنتاج أو ينتج نظريات جديدة متعلقة بالقدس والأقصى، ومن يقدم أطروحات معرفية أصيلة، تتصل بالقدس وتاريخها وما يجري فيها، والصراع مع الاحتلال على كل شبر وزاوية منها.
بل أقصد التحول الجذري الذي استجد على كثيرٍ من الجهات القائمة على نشر المعارف، وعلى الرغم من أصالة منطلق هذه الجهات وما يصفونه بأنه “تأصيل” وضبط، إلا أن الملاحظ أنّ التأصيل يجري على كيفية تدريس هذه المعطيات، لا على توسعة نشرها بين الناس، فتجد المبادرات والأطر تضع المزيد من المحاور، فتتعقد الدورات ومراحل إتمامها، ويغدو التنظيم أشبه ما يكون بالصفوف الدراسية ولكنها بأنساقٍ يتداخل فيها التقليدي بما سواه، ومع كل حركة لتأصيل الدورات المقدسية، يتضاءل الهدف الأساسي منها، وتستغرق هذه الجهات أكثر في التفاصيل، والمفاضلة بينها، ومن ثم العودة إلى تأصيلها مرةً تلو المرة.
الإشكالية التي أراها، أننا نقوم ومن دون أن نشعر، بوضع سقف لمن يريد أن يعمل للقدس.
كيف بدأ الجنوح ولماذا؟
أظن أنّ هذه الدورات تنطلق عامة، من فكرة جوهرية، أنّ الفرد كلما عرف عن القدس أكثر، استطاع خدمتها بشكل أفضل وأميز. ولكن الدائرة المفرغة من الدورات المجردة، لم تُنتج – في كثيرٍ من الحالات- مبادرات تحوّل الدارسين في هذه الدورات، إلى أصحاب مشاريع لخدمة القدس وقضاياها، بل تحوّلت إلى سيرورة متواصلة من تكرار المعرفة، والتوجّه نحو تأصيلها وما يتصل بذلك، من اختيار المواد ودراستها وتمحيصها، واختيار المحاضرين، ومن ثم وضع آليات التقييم لتخريج المشاركين.
وتصل خطوات “الإتقان والدقة”، في بعض الأحيان إلى تحويل كل ذلك من أداة لتفعيل العمل الشعبي، وإطلاق المبادرات لنشر الوعي والثقافة واستنهاض الهمم للعمل للقدس، إلى شكلٍ جديد من “الأكاديميا” المجردة، التي تدور في فلك “العلم” على الطريقة الجامعية الأكاديمية الحديثة، وتنزع منها نوازع الإسقاط على أرض الواقع، فتتضخم دوائر التدريب والأبحاث ومن ثم الشهادات، ويتم استنساخ تجارب سابقة، قد آلت إلى مساقات أكاديمية منغلقة بين جدران هذه الجامعة أو تلك، وتصبح كل قضية لا يُمكن أن تناقش إلا في مساقٍ أكاديمي، لا يتسع له المجال ولا يمكن الإحاطة به، إلا لثلة مختارة من الدارسين، ويجب أن يكونوا حصراً من طلبة الدكتوراة، يقضون فيه عاماً دراسياً، أو قُل فصلين دراسيين بمصطلح المشرفين على تلك البرامج ذات البعد “المقادسي”.
الإشكالية التي أراها، أننا نقوم ومن دون أن نشعر، بوضع سقف لمن يريد أن يعمل للقدس، لا يمكنه تجاوزه، فعليه أن يكون منخرطاً في واحدةٍ من هذه المساقات الدراسية، يكتفي به ولا يتجاوزه في كثيرٍ من الأحيان، على الرغم من أنّ الهدف الأولي كان تأهيل العشرات من العاملين للقدس والأقصى، وإيجاد رواحل مهمتها الأساسية ردم الهوة بين المعرفة المجردة وبين أدوات إنزالها على أرض الواقع.
وهنا كان التحوّل المهول من صناعة “المثقف المشتبك” بتعبير باسل الأعرج رحمه الله، إلى نمطٍ جديد من الأكاديميين ينحصر اشتباكهم في الانخراط في هذه الدورات، أو في أفضل الأحوال أن يصبح مدرساً في واحدةٍ منها يتفاعل مع طلابه عبر بوابةٍ إلكترونية دورية إلا من رحم الله تعالى.
وأمام هذه الحالة أجد من الضرورة بمكان أن نعيد التفكير في مثل هذا الانغماس المتنامي نحو الأكاديمية في المعارف المقدسية، أو التخصص المبالغ فيه، التي تبتلع أهدافنا الكبرى، وتُغرق أصحاب المبادرات والدارسين في تفاصيل كثيرة تتصل بالمناهج والأساليب والمعارف، ومن ثم الحضور والأبحاث ومتطلبات التخرج، وغير ذلك. وتنزاح رويداً رويداً عن اللُّب، ألا وهو خدمة القدس ومسجدها وقضاياها.
أخيراً، هي دعوة صادقة من القلب، من شخص يعاين تجارب كثيرة.. “دعوها فلا تفلسفوها”.