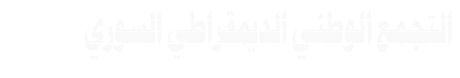أعرف أنّ الإنسان لا يستطيع قول كلّ ما في يدور في خلده، أو كلّ ما يفكر فيه، وأنّني على الصعيد الشخصي أتجنّب إبداء رأيي في كثير من الأحداث، ولو كنت قادرًا على ذلك، فأنا لا أملك طاقة أولئك الذين يدبجون المنشورات الطويلة للحديث عن أمر ما، وليس لي مران على أيّ جدال، ربّما هو شأن قديم، ولكني أجد أنّ حركات أصابعي على لوحة المفاتيح، من الأجدر أن تكون في كتابة شيء مفيد، لا في جدالات لا تنتهي…
عمّ كنت أريد أن أحدّثكم؟ ضربني النسيان مجددًا، كانت الفكرة تتقافز أمامي طيلة النهار، إلا أنني أضعتها. ومع إضاعتها، خطرت لي فكرة أخرى: لم لا أدوّن حوارًا مع أفكاري، أحدّثها وأستفسر منها، لماذا تغيب عني أحيانا، وتلتصق بي وبمخيالي في أحيانٍ أخرى؟ وفي سيرورة هذا التخيّل، تذكرت ما كنت أريد الحديث عنه، وسأروي لك الأولى، فإن تذكرت الثانية، ستُصبح هذه التدوينة أوسع قليلًا، أو قل أكثر هذرًا، سامحني الله وصبّرك عليّ.
دائمًا، تشغلني قضية اختصار الكثير من الجهات في أشخاص محددّين منها، أو في قمة هرمها، وهنا لا نتحدث عن قيادة المنظمة، التي تمثّل الجهة بشخوصها، أو بقيمتها الاعتبارية، إنما أقصد محو الشخصية الحقيقية لهذه الجهة، والتي تتمثل من خلال مجموعة كبيرة من المنضوين تحت لوائها، إن كانت مؤسسة إعلامية أو فكرية أو غيرها، وحصرها في شخص واحد منفرد، أو قل إن شئت، في شخص متفرّد متسلّط.
أُعجب كثيرًا بالمؤسسات التي تُطلق العنان لمنتسبيها وتفتح لهم آفاقًا رحبة في الشأن الذي يعملون فيه، وأمثلة ذلك كثيرة جدًا، وقد عاينت في مدينة إسطنبول العديد منها، ولولا أنّ بعض هذه الجهات، ممن تربطني بها صداقة طيّبة، سيعاتبني بعد نشر التدوينة، لذكرتهم لأدلّل عليهم وأجزل الشكر لهم. وتتميّز هذه المؤسسات بما تقدمه من مساحة حرّة لا تقيّد أفرادها في مساحاتهم الشخصية، أو في مساحة الظهور التي تتيحها ضمن مجال عملها، وفي الحالين هي من الأمور المحمودة المطلوبة.
ولكن الحالة الأخرى، والتي لا أعرف تفسيراً لها، هو حصر هوية هذه الجهات في شخص رئيسها عادة، أو أحد الأشخاص المبرزين فيها، في مقابل “دفن” أيّ صوتٍ آخر. فإن كانت مؤسسة فكرية، فستجد أنّ المشاركات على مختلف أنواعها مرهونة برأس هرم الجهة تلك، فهو الذي يشارك في المؤتمرات، وهو الذي يخرج في الإعلام، وغير ذلك الكثير. وإن كانت إعلامية، فالصورة أحيانًا غير بعيدةٍ البتة… وكأن هذه الجهات لا تمتلك أيّ طاقات فاعلة، أو أنها تتقصّد دفن الطاقات لديها في مقابر المهام اليوميّة، ويظلّ ذلك الشخص مُتسيدًا من دون قصدٍ أو بقصد.
وبعيدًا عن أهمية الطاقات واكتشافها، وأهمية التنويع، تظلّ فكرة من هو التالي حاضرة بقوة، فإن غاب الرمز الذي تنحصر الأضواء عليه، بفعل مرضٍ أو موت أو غير ذلك، ليحضر سؤال: ما هو مصير هذه الجهة؟ ولو تضمنت نظمها إمكانية الاستمرار، إلا أنّ التموضع على شخصٍ واحد فقط سيصعب مهمة المداولة، والتي ستكون في هذه الحالة إجبارية.
حينما يتحدث أشخاص لهم حيثية وتأثير، يجب أن يكون ميزان الموقف دقيقًا، وأن يكون خطاب التشجيع يغلب على خطاب التقريع
أما القضية الثانية فهي الطبيعة الشخصية للإنسان وتأثيرها على منتجه في المجال العام، إذ هناك من الناس من لديه طبعٌ سلبيٌ، وتجد أنّ مواقفهم من كلّ شيء له من هذه السلبية المساحة الأكبر، آراؤه ومواقفه، انطباعاته بحق المحيطين به، أو المواقف التي يتخذها، تحذيره من أمور معينة وغير ذلك… وكلّ ذلك في الإطار الضيّق الشخصي يظل أمرًا يمكن تجاوزه، يؤثر على الشخص فقط، وعلى المقربين منه جدًا، أما أن تتمظهر هذه السمات في الفضاء العام، فهنا تكمن الخطورة.
جمعتني الكثير من المقابلات مع العديد من الشخصيات السلبية، وأقول ذلك انطلاقًا مما أسمعه منها من تحليلات وآراء، وكيف تتسلّل الطبيعة السلبية والانطباعات القاسية نحو الحديث العام وتحليل الواقع، وفي القضايا التي تتشابك فيها عوامل عدّة، تصبح هذه الآراء منفرة جدًا.
بكلّ تأكيد، تسألني عن نموذج ما؟ حسنا، سأقول لك. ففي فلسطين على سبيل المثال، يعاني هذا الشعب الصابر صعوبات بالغة، في كلّ تفاصيل الحياة وغير ذلك، ويتجه الكثير من الرموز الفلسطينية الوازنة، وخلال حديثهم عن دور الدول العربية والإسلامية، إلى الفصل بين الشعوب والحكومات، وإعطاء مساحة مهمة للشعوب في سياق بثّ الرسائل الإيجابية والحضّ على المزيد من البذل والعطاء والتفاعل، ما يضع الإصبع على الجرح، ولكنه لا يجنح نحو السلبية المطلقة. أما السلبي فلا يرى هذا، ويكون كلامه منحصرًا بأنّ التقصير كبير، وبأنّ “كلّ الناس نسوا فلسطين” وغير ذلك. وربما يكون هذا الكلام في ميزان الحقيقة فيه بعض الوجاهة، ولكنه لا يستقيم في سياق الحديث العام.
وما يعنيني في تقييم الخطاب في الإطار العام، وخاصة إن خرج من أشخاص لهم حيثية وتأثير، أن يكون ميزان الموقف دقيقًا، وأن يكون خطاب التشجيع يغلب على خطاب التقريع، وقد ذكرتني مثل هذه الشخوص بخطيب كنت أصلّي عنده في أحد مساجد بيروت، وكانت الخطبة عبارة عن مجموعةً من الأوامر ممزوجة بسيلٍ من التقريع التي لا تنتهي، وأجزم أن جلَّ المصلين كانوا يخرجون من المسجد وهم يقولون لأنفسهم “ليش الشيخ ببهدلنا”..
هذه أفكارٌ مبعثرة أحببت أن أسجلها، وربما تكون جزءًا من النقد البناء، وبعيدة عن النقض، ما هدم منه أو لم يهدم، وأرجو أن أكون في مقالي غير متغوّل على الناس، وأسعى إلى أن تكون “بقعة الضوء” مسلّطةً عليّ فقط، وأن أكون بعيدًا عن السلبية في الكلام، فلا أقع بما أحذّر منه وأدعو للابتعاد عنه.